بُردة النبي.. حكاية المرجعيات الإيرانية التي كانت تخشى إيذاء نملة ثم صاروا جلادين!



في «عباءة الرسول»، نلتقي بمفكر إيراني من أصول دينية، ابن ملا، لكنه يخالف عائلته لأنه يرى فخاً في مستقبله على هيئة عباءة الملا. في وقت لاحق، بعد أن تحول إلى الماركسية، عاد أدراجه مقتنعاً بأن «الإسلام الشيعي ظل غير ملوث في البلاد خلال الستينيات والسبعينيات. بينما أصبحت بقية الثقافة الإيرانية تقليداً للغرب». لكن مع نهاية السبعينيات، كان «الملالي» متحمسين لإعادة إيران إلى سابق عهدها، بحسب تعبير مؤلف الكتاب.
تحالفٌ ليبرالي إسلامي، أصبح ثورة المرجعيات الدينية
قام تحالفٌ من رجال الدين والليبراليين الإيرانيين بالإطاحة بحكومة شاه إيران عام 1979. وكان هناك وعد بأن التحالف سيصمد، وأن رجال الدين سيعيشون ويسمح لهم بالعيش في جمهورية علمانية تحترم الإسلام. لكن رجال الدين لم يريدوا نظاماً علمانياً. غدت السياسة الإيرانية مشبعةً بالشعور الديني، وانتهى الأمر بالحكومة الدينية. وأُجبر أولئك الذين فضّلوا حكومة علمانية على النفي، أو اختبأوا تحت الأرض. وكان من المفترض أن يتم إخماد أي تأثيرات من الثقافة الغربية. لكن بعد فترة من الهناء الوطني، سقطت إيران في قبضة نظام التعصب الديني وحكم الملالي.
بعد ست سنوات من الثورة الإيرانية، صار لدينا كتاب رائع عن ثقافة إيران، الطبقة الدينية الشيعية المسؤولة عن الثورة والمدارس، المعاهد الدينية التي خرج منها رجال الدين.
حكومة «آية الله» تمارس «ركل الأسنان»
نشبت الثورة سنة 1979 بمشاركة فئات مختلفة من الناس وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة، واستبدلته في نهاية المطاف بالجمهورية الإسلامية، عن طريق الاستفتاء في ظل المرجع الديني آية الله روح الله الخميني، قائد الثورة بدعم من العديد من المنظمات اليسارية والعلمانية والإسلامية، والحركات الطلابية الإيرانية.
في 1 شباط/فبراير 1979، عاد الخميني إلى طهران محاطاً بحماس وتحية عدة ملايين من الإيرانيين، استقبلته لدى ترجله من الطائرة الجموع الحاشدة بتحية: «السلام عليكم أيها الإمام الخميني». أوضح الخميني في كلمة ألقاها في اليوم نفسه شدة رفضه لنظام رئيس الوزراء بختيار، ووعد «سوف أركل أسنانهم لقلعها»، وعين منافسه مهدي بازركان مؤقتاً رئيساً للوزراء، وقال: «بما أنني قد عينته، فيجب أن يُطاع»، واعتبر أنها «حكومة الله» وحذر من عصيانها، فأي عصيان لها هو «عصيانٌ لله»، وفيما راحت حركة الخميني تكتسب مزيداً من الزخم، بدأ الجنود بالانضواء في جانبه، اندلع القتال بين الجنود الموالين والمعارضين للخميني بإعلانه الجهاد على الجنود الذين لم يسلموا أنفسهم.
واستشعر -حلفاء الثورة من غير الملالي- خيبات الأمل المنتظرة عندما أعلن الخميني «لا تستخدموا هذا المصطلح (الديموقراطية)، إنه مفهوم غربي». وفي منتصف شهر آب/أغسطس، تم إغلاق عشرات الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخمينية، استنكر الخميني، ساخطاً، الاحتجاجات ضد إغلاق الصحافة، وقال «كنا نظن أننا نتعامل مع بشر، من الواضح أن الأمر ليس كذلك».
بردة النبي، وحبُّ الغموض!
«عباءة الرسول» أو بردة النبي هو عمل روي متاحيده، وهو باحث موهوب يدرّس تاريخ الشرق الأوسط في القرون الوسطى واللغات العربية والفارسية في جامعة برينستون. لكنه جعل كتابه متاحاً لجمهور واسع. يكتب عن إيران مع الحنين لبلده وتراثه. وهو يناقش السبل التي عبر بها الإيرانيون عن أنفسهم، الطريقة التي تمكنوا بها من الهروب من استبداد حكامهم بالتحول إلى الشعر وجعله «الرمز المركزي لثقافتهم»، العاطفة التي يتحدث بها كل متحدث بالفارسية. إنه يضيء أسلوب الثقافة الفارسية، التي تحاول إيران الحديثة أن تدمرها: حب الغموض.
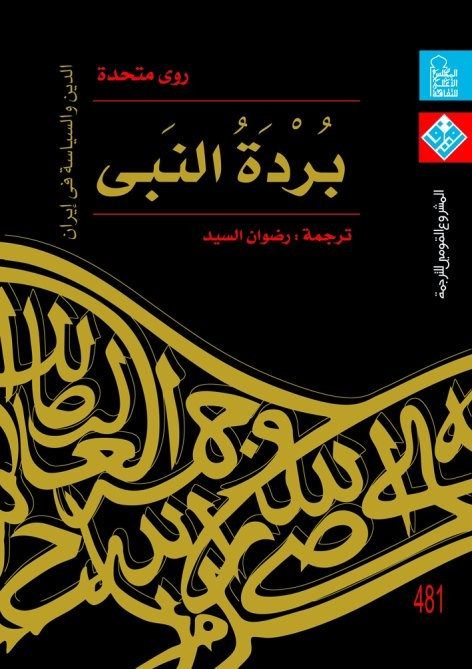
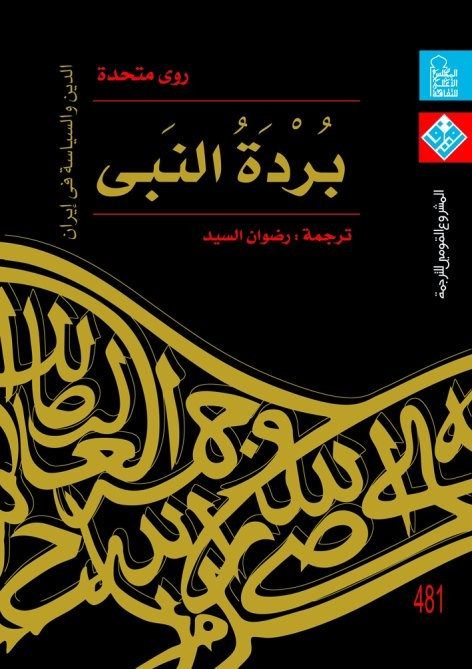
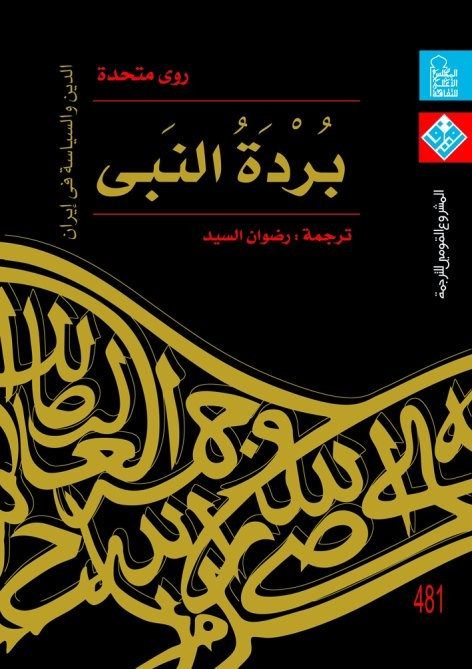
يتتبع المؤلف حبَّ الغموض، والتوتر بين ماضي إيران ما قبل الإسلام وتحولها إلى الإسلام خلال القرن السابع، بعد فتحها بأيدي العرب.
إسلام بنكهة فارسية
صمتت إيران لمدة قرنين من الزمن. سماها روي «غبية بسبب هزيمة الإيرانيين والاختفاء التام لدولتهم الزرادشتية». واشتمل الإسلام في العصور الوسطى على «نكهة فارسية مميزة».
وشكل الإسلام الذي صنع في القالب الفارسي، ثقافة عالية في العصور الوسطى، على طول الطريق من تركيا إلى إندونيسيا.
جاء التشيّع إلى إيران من البلاد العربية، في القرن السادس عشر (قبل ذلك لم تكن إيران شيعية) وتميزت إيران عن بقية العالم الإسلامي منذ هذا الوقت بالتشيّع الذي يعتبر علي، صهر النبي محمد وابن عمه، الخليفة الشرعي للرسول.
الإيرانيون بدورهم خلطوا التشيّع بروحهم وأضافوا لها رجال القانون ورجال الدين العظماء. ولم يكن من الممكن أن تجد حزن وعزلة إيران ديناً أو مذهباً أفضل.
حكاية علي هاشمي
قصة «عباءة الرسول» هي لملا شاب، علي هاشمي (اسم مستعار)، ولد في أوائل أربعينيات القرن العشرين. إنه موضوع المؤلف ونصه الأدبي. حيث السرد الكبير لتاريخ إيران منسوجٌ حول قصة حياة علي هاشمي.
هناك صوتان مختلفان في الكتاب: واحد يروي حياة علي هاشمي، والثاني هو المؤلف نفسه، الذي يصف التاريخ الإيراني.
ومن خلال علي الهاشمي نرى المساجد والأسواق الإيرانية «رئتي الحياة العامة في إيران». نحن نتبعه من خلال سنوات تكوينه في قم. وهو يباشر عمله كـ «ملا»، لأنه متمكن من الدراسات الدينية، كونه ابن الملا، ولأنه من مواليد مدينة قم، وهي مدينة للتعليم الديني العالي. وكانت الوحيدة التي عرفها حتى بلغ التاسعة عشرة من عمره. كان يحب مزاراتها وحدائقها من أشجار الفاكهة «التي تزرع بعناية فائقة في التربة الصعبة والمناخ الحار» للمدينة. في تلك المدينة -الجافة حتى وفقاً لمعايير المدن الإيرانية- كان آلاف الطلاب الشباب مثل علي هاشمي يأخذون منهجاً دراسياً صارماً مثل بلدة قم نفسها.
قمّ، هنا بدء كل شيء خارج الثكنات العلمانية!
جاء علي هاشمي وأقرانه إلى قم من المدارس الابتدائية التي تديرها الدولة. بدأ العلمانيون في إيران في منتصف القرن التاسع عشر بوضع أسس التعليم مدعومين من الملوك الذين أرادوا أن يركّزوا على الدولة الإيرانية والذين طبعوا المخططات (المدارس التي يعلّم فيها الملالي القرآن ومهارات القراءة الأساسية). أراد الملوك الإيرانيون أن يتم تدريب جيوشهم، ويتعلموا المهارات العسكرية. وهكذا بقي التعليم العلماني في إيران «مخلوقاً للثكنات، مع تأكيده على النظام والعقوبات الجسدية». كانت روح التعليم «مزيجاً غريباً من تعليم الفرنسيين والملالي في القرن التاسع عشر».
لكن المدينة التي نجت من الموت وسكانها. أصبحوا، أكثر من أي وقت مضى، حصونَ الأرثوذكسية الشيعية. وحافظوا على تقليد علمي، كان على حد تعبير أحد الملالي الساخطين، «حفرة كبيرة وعميقة إلى حد ما». وبالإضافة إلى الحفاظ على النصوص القديمة، ظل الطلاب والمدرسون في المدارس يراقبون بلادهم، وكانوا يشعرون بالاستياء العميق، ضد مجتمع حديث يمر من خلالهم وينتظرون وقتاً يمكن فيه تسوية الحسابات مع المجتمع العلماني في إيران ومطالبته.
حينما انحسر المد الإسلامي ثم جاءت ثورةٌ إسلامية غاضبة!
بين الحين والآخر خلال الخمسينيات والستينيات، اجتاحت المشاعر السياسية رجال الدين. لكن على العموم، عاش الفصيلان الإيرانيان، الديني والسياسي، «بشكل منفرد في تعايش سلمي». لكن في السبعينيات من القرن الماضي، تحطمت الحياة الإيرانية. لقرون كانت إيران تتسامح مع الألغاز. وفي التقاليد الفارسية، لم يتم حل الألغاز بل تُركت وحدها. الآن الجميع -الشاه وخصومه الدينيون- أرادوا حل الألغاز. في عام 1971، في احتفال سيئ السمعة في بيرسيبوليس، جعل الشاه، نفسه كورش الكبير في العصر الحديث، وكورش الذي هو مؤسس الإدارة الفارسية ما قبل الإسلام تم تعظيمه؛ تضاءل المد الإسلامي. ثم جاءت ثورة إسلامية غاضبة!
كانوا يخشون إيذاء نملة، ثم صاروا جلادين!
ووفقاً لـ»علي هاشمي»، فإن الملالي الذين كانوا يغيرون طريقهم «لتجنب مزاحمة نملة» أصبحوا جلادين لا يرحمون. في وقت لاحق، أعطت الحرب المستمرة مع العراق الملالي عصاً يمكن من خلالها تجميعُ الجماهير. أصبح رجال الدين الذين تدربوا في «المناهج القاحلة» من البلاغة والمنطق والفلسفة، أصحاب منطق الحرب والبنادق، و»منفذي أحكام صارمة». لقد انتصر رجال الدين الشيعة والناشطون. لكن انتصارهم وتطرفهم وضع تقاليد فكرية كاملة في خطر. يقلق علي هاشمي من أن التقاليد الإسلامية التي يتقنها بقدر كبير من الولاء والجهد يمكن أن تضيع.
سياسات الغضب الذي لا هوادة فيه!
الأرض التي كان علي هاشمي، رجل دين شيعي عصري، قد استسلم لها. مثل تقاليد ضبط النفس والتسامح الذي يمثله -التقليد الذي يتناوله المؤلف متحدّاه باحترام- اختفى وخسر لصالح تفسير لا رحمة فيه للإسلام من قبل الملالي المتحمسين المتلهفين إلى استئصال ما رأوه كفساد ونجاسة وتدمير «أعداء الله». لكن في إيران -وفي العالم الإسلامي الكبير- أدت سياسات الغضب ونفاد الصبر إلى ضياع مفاهيم التسامح القديمة.
بئر علي هاشمي المجوّف
لا يتوقع متاحده ما يخبئه المستقبل لتقليد التشيّع القديم، المتمثل في ضبط النفس والتعلم. لم يكتب هذا النوع من الكتابة. لكنه يتركنا مع الفراغ الموجود في حياة علي هاشمي وهو «بئر مجوف يمكن أن يصل إليه دون أن يشعر بالقاع!» مع هروبه إلى حديقته وكتبه، من جانب، ومع «نفور عنيف للعنف». من ناحية أخرى، هناك الملالي الذين ألقوا بأنفسهم في خضم السياسة والحكم «من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم» في إيران وأيضاً في التدخلات الخارجية في بقية العالم الإسلامي.
ولّد النظام القديم الذي جسّده الشاه، غضباً هائلاً. وهذا الغضب لم ينفق بعد ولم يتم تفريغه حتى الآن. والمؤلف يعرف ذلك. لكنه يحاول إحياء زمن اختفى!
إيران الثورة، هل تصنع السلام أم الغضب؟
علينا أن ننتظر أن تصنع إيران سلامها مع نفسها ومع العالم. لكن علينا بذل جهد أيضاً. «عباءة النبي» هي عمل للمصالحة والتفكير. يرتفع فوق العداء الحالي بين إيران وبين محيطها والغرب، ويتحدث عن مشاعر أكثر هدوءاً. وكما هو الحال مع الشعر الفارسي الذي يتحدث بصورته الرمزية، فإنه يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية وجود عالم يتجاوز الغضب والمرارة.
وجد روي متاحيده، وهو مؤرخ في الشرق الأوسط، نفسه مطلوباً، حيث سعت شبكات التلفزيون إلى الحصول على رأيه. لكنه رفض. وقال في مقابلة هاتفية حديثة «الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يفعلون بعد ذلك.» وفي هذا الصدد، أشعر بالحيرة مثل أي شخص آخر». يضيف متاحده «إن الأمر يتطلب أحداثاً كبيرة وأحياناً مروعة للغاية لجعل الناس يريدون قراءة ثقافة أخرى بشكل أكثر عمقاً، وأعتقد أن الكثيرين أصبحوا الآن مستعدين للقيام بهذه القفزة».
